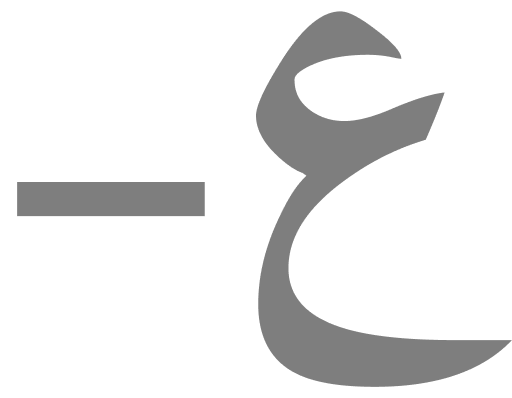منذ عهد الأجداد والآباء، كان الخليج محطة كبرى لتلاقي شعوبه وتلاقح الأفكار، وتبادل الوظائف والأعمال. الوالد وأقرانه، رحمهم الله، جابوا الخليج العربي من أطرافه، فلا حدود الجغرافيا السياسية أوقفتهم، ولا السدود النفسية رفضتهم للعيش حيثما حلوا أو ارتحلوا.
وعندما حل الاستعمار ببلدان الخليج العربي، كبقية البلاد العربية لم يتمكن من تغيير هذا البعد العميق في نفوسهم، ولم يؤثر ذلك في دينهم، ولا عاداتهم ولا تقاليدهم ولا موروثهم الشعبي، ولم يؤثروا شعرة في لغتهم ولا لهجاتهم المحلية، رغم أنهم أتقنوا لغتهم من غير دراسة وعلى أميتهم، بل بالممارسة اليومية، وخاصة ممن عملوا في الشركات الأجنبية، التي بدأت آنذاك، في غرس أرجلها بأرض الخليج.
أما نحن، جيل الأبناء، فقد كنا كذلك في تماس مع هذه اللحمة الخليجية التي فتحنا أعيننا عليها في فترة مبكرة من أعمارنا.
دعاني أحد أصدقاء الوالد، وكلاهما في ذمة الله للسفر إلى البحرين، وكانت أول رحلة لي في بداية المرحلة الثانوية، ولم أتصور بأن أهل حضارة «دلمون» يعاملون «الغريب» أقرب إليهم من القريب، فلم يبق «فريج» لم يسمع بقدومي ضيفاً على الجميع.
ومنذ اليوم الأول كانت بيوت الجيران تحتفي بوصول ضيف من الإمارات، وتتنافس بـ«الأيمان المغلظة» لكسب فرصة استضافته.
أما في سلطنة عُمان، فكانت «الباطنة» ملاذاً لنا في الصيف، نلعب في مزارعها ونسبح في أحواضها وشواطئها، ونأكل من ثمرات النخيل، ومن أشجار المانجو ما لذ وطاب.
ففي أوائل التسعينيات درسنا في بريطانيا مع نخبة مميزة من طلبة السعودية المبتعثين، وكان معي طالب في الدراسات العليا في التخصص نفسه. نما إلى علمه بأنني قررت العُمرة في رمضان، فحلف بأن أكون في ضيافتهم هناك، وعندما وصلنا إلى مطار جدة، فإذا هو في استقبالنا لاصطحابنا، ولم يدعنا إلا ساعة الوداع والعودة إلى لندن، هذا الرابط الاجتماعي، وبلا مقدمات أو سابق معرفة له دلالة قوية على الجذور الطيبة وأصالة الطباع والخلق السامي والمنزلة الرفيعة للأكرام من أهلنا في المملكة العربية السعودية.
ففي الغربة كانت مدارس المملكة العربية السعودية محضناً للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لأبنائنا، ونادي الطلبة السعوديين مكاناً اجتماعياً لأسرنا في رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية.
ففي الكويت شهادتي مطعونة، فهي التي علمتني الحروف الأولى، وأكستني الملابس المدرسية الأنيقة، وعندما ارتقينا في سلم التعليم، وأتممنا واجبه وزرنا الكويت مرات عدة، لم نجد من أهلها وحكامها الذين التقينا بعضهم غير دفء الترحاب، فلم يبخلوا علينا بكرم حفاوتهم، وسعة قبة برلمانهم وديوانياتهم، والسكن في أعماق قلوبهم قبل كل ذلك.
نأتي إلى قطر، وبالنسبة لي، فأبناء آل مكتوم الكرام، وآل ثاني، كانوا لي زملاء دراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية.
هذه الُّلحمة التربوية هي التي كانت تسود أبناء آل مكتوم، وأولاد آل ثاني، ومعهم أبناء الشعب بلا فواصل ولا حواجز بيننا، كنا نلعب معاً، ونأكل ونشرب لبن الناقة في دورهم وقصورهم، ونسبح على شواطئ البحر برفقتهم، ونرحل إلى مزارعهم وعزبهم، ونشق عباب البحر في يخوتهم.
هكذا عشنا معهم إلى أن بلغنا هذا العمر، ولم ننقطع عن المرور على مجالسهم حتى جاء زمن أولادنا، وهم يواصلون ذات النهج مع أولاد الشيوخ الكرام، بل لقد دُعيت العام قبل الماضي لحضور حفل زفاف أحد أحفاد آل ثاني ممن يقطنون الشارقة، فإذا بمعظم شيوخ الإمارات في مقدمة الحضور، فأيّ لُحمة أو وشيجة أقوى وأقرب إلى قلوب شعب الخليج من هذه.
*كاتب إماراتي