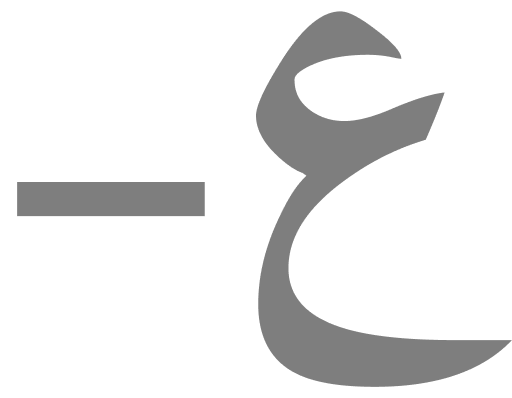أسرار غامضة وتفاصيل دقيقة تستقر في قصة كل منا، تلك التي تروي سيرة نشوء أفكارنا، ومواقفنا ومبادئنا، منقسمةً في كل ما تحمله لموقف يتلخص باختيار واحد من ثنائية «الحب والكره». إن هذه الثنائية تشكل دائرةً متسعة المدار، وقد تبدو «ملساء» بلا حواف حادة ولا زوايا ثابتة، لكنها في مضمونها تحمل الحدة ونقيضها، لا سيما أن الحب والكره يتصلان كمحرك دافع للسلوك، وموجه للمشاعر، وكأنها تشبه تجديداً وبناءً لـ«برمجة» العقل وتوجيه القلب. وحين وصف المولى سبحانه وتعالى الكلمة اللينة الطيبة الخيّرة، وشبهها بالشجرة الطيبة ذات الجذر المتين الثابت في الأرض، والامتداد الكبير وصولاً للسماء، نجد أن أساس هذا الانطلاق الطيب منبعه القلب والعقل، حيث تستقر المصانع والمولدات الضخمة لـ«الحب».
وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في فخ الكره وتوجيه مشاعرنا نحو السلبية، وذلك بقوله: «دبَّ إليكم داءُ الأممِ قبلكم: الحسَدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالِقةُ.. أما أنِّي لا أقولُ تحلِقُ الشَّعرَ، ولكن تحلِقُ الدِّينَ»، فإن هذا يدل على خطورة تتجاوز اعتبار الكره مجرد رأي شخصي، أو موقف فردي فهو يتغلغل في صدر المؤمن حتى يفسد عليه شعورَه الإيماني. وإن هذا لا يبدو متشابكاً معقداً، بل مترابطاً ومنطقياً، فالإنسان حين يخرج عن ماديته باعتباره ذا صلة وجدانية، واتصال دائم مع الخالق سبحانه وتعالى، تنافى هذا السمو مع وجود ما يعكر صفوه من غل أو حقد يفسد سكينة القلب وطمأنينته، وبالتالي فهو داء يضر صاحبه أكثر من غيره.
يقول الأديب اللبناني جبران خليل جبران: «حياة بدون حب شجرة بلا زهر أو ثمر». إن فطرية الحب التي أنعم الله بها علينا، تمتد في شتى ملامح حياتنا، وصور تعاملنا وسلوكنا، فهي سبب في التقويم لأفعالنا، ودافع للإنجازات المحمودة، ومكون «نقي» للبغض الذي لا حب فيه، ككرهنا للأعمال المذمومة والأخلاق السيئة والتصرفات «منزوعة الخير»، وبالتالي فالكره يكون مطلوباً حين ينبع عن حب «متزن» محوط بقصد الخير، فما من أحد فينا إلا ويكره الإرهاب حباً بالسلام، ويكره الكذب حباً بالصدق، ويكره الخيانة توقاً للوفاء.
إن أثر الحب على الدماغ يتجاوز تلك الحالة المتوازنة التي نعيشها مع أنفسنا، إذ يعمل على إضاءة مناطق مهمة للغاية في أدمغتنا، كتلك المسؤولة عن تحسين الذاكرة، وبناء المعارف، والتعاطف، وتقليل الألم.. وكأنه نور مشع في ظلمة الطريق!
وللحب العديد من المعاني والارتباطات الدلالية التي تختلف في سياقها مرة لتكون عاطفة جنسية، ومرةً أخرى صداقة ومودة، ومعانٍ أخرى ذات جذور مع الإنسانية كالمبادئ التي تنظمها وتتوجها بالعديد من القيم والأخلاقيات كالتسامح والتراحم وغيرها. وإن إمعان الحب يؤدي بنا لخلاصة دينية نفسية سلوكية صحية، وفكرية، فمن جانب الدين، فالحب عماد البناء الإيماني وصمام سلامته. وفي الجانب النفسي فإنه خطة نجاة من تحديات كثيرة أقلها القلق، وفي السلوك فالحب وقوده النقي، أما الصحة فلا مبالغة إن قلنا إن الحب «حياة» جميلة وسعيدة خالية من الأمراض المزمنة، واضطراب الهضم، وخفقان القلب، وفي الفكر فإن عاطفة الحب ما دامت متزنة فهي قادرة على بناء المعارف دون تهور أو تحيز.
وعليه، فإننا اليوم ومثل كل يوم، نضيف لقائمة احتياجاتنا واهتماماتنا ما نحصده من ثمار معرفية قيمة، وبالتالي فإنا نتطلع لتعلم الحب، كما نتعلم أبجدياتنا، فمتى نحب؟ ومتى نكره؟ وكيف يمكن استثمار ثقافة الحب، في بناء «أدمغة» أكثر سلاماً وتصالحاً وحباً، تنعكس على طاقة المجتمع ومدى تنميته وازدهاره، وتفوقه بين مراتب الدول أخلاقياً وسلوكياً، وما سواها من مجالات.
*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة