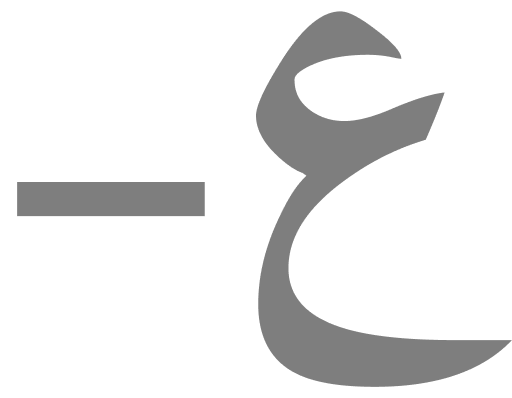يذهب الشاعر إلى البحث عن جوهر المعنى في تفاصيل الحياة كافة. وبينما يعبر الرجل العادي في الصحراء ويراها مجرد خواء وجفاف، يكتب الشاعر من وحيها أروع القصائد، واصفاً رقصة الريح فوق التلال الجرداء، ومترنماً بنغمة النسيم البرّي الذي يهبُّ من جهة الغموض، ويمنح لهذا الامتداد الصحراوي سحره وروعته، ويدعونا للتأمل في تحولاته وقوافيه. وفي الصحراء، يكون لمشهد غروب الشمس شكل مغاير لمشهد غروبها على البحر عندما تبتلعها الموجة، ونراها تغوص في زرقة الأعماق، بينما يتخذ مشهد غروب الشمس في الصحراء بعداً آسراً تبدو فيه الرمال، وكأنها تتفاعل وترتفع في موجات ترابية، وكأنها تلوّح بالوداع.
وما يُدهش حقاً، أن الشعراء ينتمون جميعهم إلى سلالة الترحال حتى لو اعتزلوا في الزوايا والأركان. إذ ترحل القصيدة من بحر لبحر، وترتفع من لجّةٍ الى عالي سماء. ويلذُّ للشاعر أن يتلاعب بالمتناقضات لتوليد المعاني المغايرة والجديدة. وبدلاً من تتابع الكلمات في سياقها المنطقي، نراه يدمج بين الثلج والنار، ويضعهما في كفة واحدة لضبط إيقاع الحياة. وكأنما يريد الشاعر أن يخلق قانوناً للأشياء خاصاً به وحده، فنراه يعاند الجاذبية جاعلاً الخيول تطير فوق الغيوم، وربما اختار أن يصف الأنهار بأنها عروق الأرض، والبحر مجرد سجادة زرقاء.
هذه القدرة على توليد الخيالات الغريبة، تثير هي الأخرى مخيلة القارئ، وتدفعه للتحرر من قيد الأفكار المغلقة. ومن يقرأ الشعر ويُدمنُ عليه، يتحول بالتأكيد إلى مبدع في مجاله، بما فيهم العلماء أنفسهم المعروفون بالدقة والنظام والخضوع الى القياسات والحسابات. وأذكر أن العالم آينشتاين حين سألوه كيف توصلت إلى اكتشاف النظرية النسبية، أجاب ببساطة: باستعمال الخيال.
لا تقف أهمية الشعر إذن عند تذوق الجماليات في اللغة والتعبير وإبداع الصور الفنية فقط، بل تمتد الى توليد الأثر في العقل والحس الإنساني. أيضاً يذهب هذا التأثير إلى مكامن غير مطروقة وغير مرصودة نقدياً.