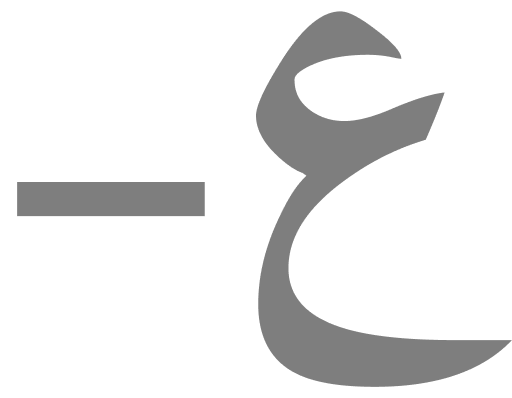تحمل القصيدة وجدان صاحبها، ولكنها من أفق آخر تعبّر عن وجدان أمة وشعب. ومن يرصد القيمة الجمالية في الأعمال الأدبية، يدرك أن للبعد الروحي في النص مكانة وحيزاً. إذ لا يمكن أن يستقيم النص من دون أن تكون له تلك الخاصية الروحية التي يشعر بها القارئ كلما توغل في فهم وإدراك المعنى الأدبي. ولذلك يقال أحياناً عن بعض أنواع الكتابة إنها جافة، وبلا روح، إذا كانت غير مشبعة بالمعاني التي تُضفي على الكتابة مسحة إنسانية عالية من تدفق المشاعر والأحاسيس. وينطبق هذا على القصيدة والرواية والقصة والتجلي الإبداعي بأشكاله كافة.
في الكثير من الأعمال الشعرية المترجمة على سبيل المثال، نلمس بعمق هذه الظاهرة من الجفاف. ولذلك قيل إن من يترجم الشعر يجيب أن يكون شاعراً. ونضيف عليها أن كل من يتصدى لترجمة الأدب، يجب أن يتحلى بهذه الروح العالية من الحس اللغوي والإنساني أيضاً. أما على صعيد المعنى الروحاني للأدب، فهذا أفق مختلف ومتشعّب، ولكن من المجحف حقاً أن نسمّي بعض الأعمال الأدبية ذات المسحة الدينية أو الصوفية بأنها وحدها فقط أعمال تنتمي إلى الأدب الروحاني من دون غيرها. إذ تظل كل قصيدة، تحمل هذا البعد بشكل أو بآخر، سواء كان الشاعر يناجي السماء، أو حتى يخاطب المرآة ويطرح عليها أسئلة الوجود والحياة والمصير.
في الثورة الأدبية الحديثة، تداخلت أشكال وأنماط الكتابة، ولم يعد تصنيف الأعمال الأدبية يقتصر على الأنواع التقليدية (قصة - قصيدة - رواية - مسرحية.. الخ) بل ظهرت لنا نماذج كثيرة تدمج كل هذه الأشكال معاً في نص أو كتاب واحد. وينطبق ما يحدث في الشكل على التغيير في المعنى أيضاً، إذ يتحتم على هذه الأنساق الجديدة من التأليف، أن تنهل من الأبعاد الروحية المختلفة للأدب، وتدمجها في بنية موحدة بما يضمن لهذا الجنس الأدبي الجديد أن يمتلك مقومات اكتماله. ولن يكون مستغرباً أن نقرأ عملاً أدبياً يخلط بين الحب والحرب ومناجاة النفس والروح وصرخات الألم وتأوهات الشوق في تكوين واحد.
ما نراه ونقرؤه في الأدب، هو صورة الحياة عموماً. حيث ننتقلُ سطراً بعد سطرٍ، من بعدٍ روحي إلى بعدٍ مادي، ثم نقف أمام مرايا الأسئلة وأجوبة معنى الوجود. وقد نضحك أو نبكي، وقد نغرق في الصمت بانتظار كلمةٍ حانية.