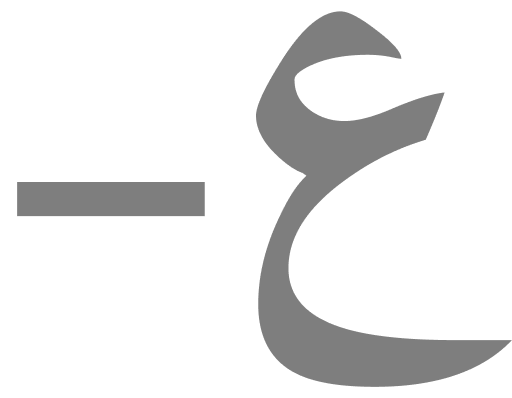نحنُ المؤيدون للوردة، نعترفُ بأننا نرى الحقيقة فقط في الجمال الأسمى، الذي يتجلى على شكل وردةٍ تنبتُ في براري الشوك، وتظلُّ تفوحُ بالمعنى من غير أن تبالي لو حاصرتها الأيادي القاطفة الخاطفة، أو مُدت إليها المناجلُ العمياء. ومن شيمة عزمنا أننا نقدّسُ البياض الناصع الذي في الورقة ونظنّه رمزاً للوضوح وشكلاً للأمل. وإذا حاصرنا الدخانُ في ليل الغموض، أضأنا شمعة العارف وبددنا بها لوعة الشك، وبثثنا نورها لحناً في أغنية الغد الجديد.
في كل صبح، نهتفُ للضوء وقد بجّلناهُ إلى درجة أن صار يحسبنا الغافلون بقايا أشجارٍ قديمة. وعند الظهيرة، نصعدُ تل الذكريات ونرمي من عليها أسف الأيام الآفلة. نقول هذا، وقد دربتنا الأيام على حماية الوردة حتى لو أدمت أصابعنا أشواكها. والوردة في عرف قلوبنا هي الوطن والأم والحقيقة ورسائل الندى للندى.
يقولُ شاعرُنا وهو طفلٌ: أنا برعم الذاهبين إلى اكتشاف ذواتهم في السؤال. لكنه حين يكبرُ، يصير صوتاً في حشرجة الأقلام النافرة، وربما تمادى وراح يصفُ الحياة بأنها تُعاش على مبدأ الحب ولا شيء غيره. نعم، ونحنُ رأيناه يوماً يتسلق الغيمة وينفخُ في أذنها كي تمطرَ على الصحاري ليروي حبرها قصيدة الرمل. إنه الشاعرُ الذي يحملُ في فمه الناي، ولا يفهم لغته سوى الشجرة والغزالة والقلوب التي تعرفُ كيف تُصغي إلى نبض هذا الكون، وتبحثُ عن المعنى المخبوء في الجوهر والعمق.
في المساء، لا يكفي أن يطلَّ علينا قمر الأمنيات البعيدة، ولا تتدفأ النارُ إلا حين نسردُ لها عن مولد الوردة قرب نبع الطفولة الأولى. عندما كان علينا أن نختار بين النار وضدّها، وبين الرجوع إلى الزاوية أو الخروجِ من أسرها. وكان كثيرون قد صدّقوا الوهم، واستكانوا لخدر أن يعيشوا مطمئنين تحت مظلة الخوف، لكن الذين آمنوا بالوردة، أدركوا أن الذهاب إلى الاكتشاف هو أوّل الكلمات الصادقة وأول خطوة للوصول. ثم جاء رجلٌ عجوزٌ في يده مصباح الشمس، وقادهم في الليل الطويل إلى منبت الفجر، وهناك شيّدوا فكرة البداية وراحوا يسقونها من عرق الحنين حتى أزهرت وعداً بالخلاص ودحر الندم.
نعم، نحن المؤيدون للوردة. رفعناها تاجاً على رؤوس عشيقاتنا كي تنوب عن القصيدة. وقلنا للرسامِ أن يثبّتها في لوحة الخلود على شكل فراشة تطير من قلب لقلب، وتنشر عبق الحب في الكون كله.